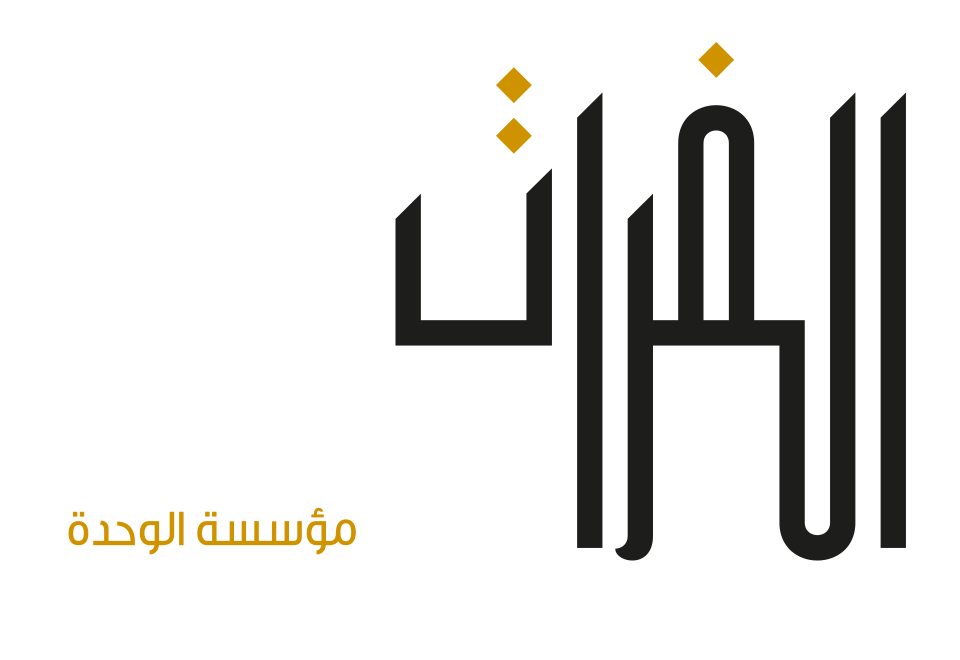إن اندثار حضارة ما برموزها وملوكها ومعابدها لا يعني بالمطلق أنها لم تترك جزءاً منها في اللاوعي الجمعي لأبناء المنطقة، فكيف إذا كانت هذه الحضارة تعقبها حضارات وحضارات، فلا بد إذاً من أن مجموعة من العادات والمعتقدات الموروثة ستتداخل إلى درجة يصعب معها فك الاشتباك أو تحديد الأصل أو الانتماء الحقيقي لعادة أو فكرة معينة، وهذا ما ينطبق على ما يسمى في دير الزور شموع الخضر تلك الظاهرة التي تربط بين الماء والنار والأمنيات.
عرفها الباحث عمر صليبي بقوله: «هي ظاهرة اعتقادية تتم بوضع الشموع على قطعة خشب توضع في مجرى النهر بعد اشتعال هذه الشموع وتركها تطفو على سطح النهر.
آني نذرن عليا/ أطوف شموع بميا ينظرني الرايح والجاي/ كله علشانك يا هواي وأعطي للي يراضينا/ هالخاتم البديا
وطواف الشمع تقليد عالمي وليس محصوراً بالعرب إذ تمارس هذه الطقوس في بلاد فارس والهند واليابان، لا بل في كل المناطق ذات الأنهار الجارية ومناطق البحار والتي تعتمد على التفكير الديني في أسلوب معاملتها تاريخياً، إن الآسيويين مثلاً يلجؤون إلى مثل هذه الظاهرة في مناسباتهم وأعيادهم الدينية، وترى نهر الغانج ونهر البراهما بوترا إلى الآن يغص بالناس والشموع في مواسم دينية معينة، إذ يطهرون أنفسهم من الذنوب بهذا العمل حسب اعتقادهم، كما يرفعون النية في إيفاء النذور ويأملون بالخير، ولعل ظاهرة شموع إنما تشير إلى وحدة التفكير الديني والأخلاقي لساكني الجنوب والشرق الآسيوي على وجه الخصوص والتي تأثر العرب بها من جراء قصة الخضر عليه السلام مع الحوت وسيدنا موسى عليه السلام التي ورد ذكرها في القرآن الكريم
وعن الطقوس المرتبطة بهذه الظاهرة التقينا السيدة سعاد الصالح ربة منزل 70 سنة والتي حدثتنا عن توقيت طواف الشمع والحيثيات المرتبطة به قائلة: «هذه العادة أي تطويف شموع الخِضِر يمكن أن نراها في كل أيام السنة ولكنها في 15 شعبان تأخذ شكلاً جماعياً حيث إن قسماً كبيراً من نساء المدينة والريف يذهبن إلى نهر الفرات ليعشن هذا الطقس، وذلك بعد غروب الشمس، تحمل كل واحدة منهن شموعاً وقطعة خشب تشعل الشموع المثبتة عليها وتتركها للنهر الجاري، وتظل تراقبها حتى تغيب عن الأنظار، وانطفاء تلك الشموع تعتبره المرأة إشارة إلى أن أمنيتها التي طوفت الشمع من أجلها لن تتحقق، أما إن ظلت الشموع مشتعلة حتى تغيب عن النظر فإن هذا يجعلها تتفاءل بإمكانية تحقق أمنيتها».

أما فيما يتعلق بمصدر تلك الإشارة في أذهان هؤلاء النساء إن كانت تتعلق بالنهر نفسه وقدسيته أم بالله عز وجل فأضافت: «لا أعتقد أن هذا الخاطر جاء في أذهان هؤلاء النساء ولا استطيع أن أجزم به، ولكن الذي لا يختلف عليه اثنان أن لهذا النهر قدسية ارتبطت في السابق بالكثير من الأساطير التي لا تموت بل تظهر في كل حقبة زمنية بصورة جديدة، فهذا النهر هو رمز الخصب والخير من جهة، وطريق للمواصلات أيضاً، فهو الطريق الذي يرجع منه الأحباب لكون الملاحة النهرية كانت ناشطة فيه قبل عقود فالنهر شريان الحياة لكل المقيمين إلى جواره فهو مصدر رزقهم وموئل أمانيهم».
ولا بد من أسباب أدت إلى نشوء مثل هذه الظاهرة أو بالأدق تجددها قبل عقود لتأخذ هذه الصبغة الجماعية، حول هذه الفكرة أضافت قائلةً: «أول تلك الأسباب وأهمها صعوبة الحياة التي كانت تحياها المرأة بصورة خاصة وتبعيتها الاقتصادية للرجل، فلم تكن تجد في ظل هذه القسوة والقهر سوى الأماني منقذاً لها، فالفتاة التي تنتظر عريساً تطوف الشمع على أمل قدومه، والمرأة التي لا تنجب تطوف الشمع على أمل أن استمرار اشتعاله سيعطيها إشارة تنبئ بأن مأساتها ستنتهي، وطبعاً كان لغياب الوعي الديني وللجهل دور كبير في ذلك
أما حول أماكن انتشار هذه الظاهرة وبداية تلاشيها فقد أضافت قائلة: «هذه الظاهرة كانت منتشرة من منبع النهر وحتى مصبه وفي دير الزور كانت موجودة طوال مجرى النهر وفي منابع مائية أخرى مثل عين علي ولكن كانت في المدينة أشد منها وطأة في الريف حيث المرأة كانت إنسانة عاملة وبالتالي فإن مساحة الأماني عندها أكثر تقلصاً، أما فيما يتعلق باندثار هذه الظاهرة فلا أستطيع أن أجزم به فربما تجد نساءً يمارسنها إلى الآن، ولكن أستطيع القول إن طقسها الجماعي لم يعد موجوداً منذ عقد أو عقدين».
أما فيما يتعلق بالشرائح الاجتماعية التي كانت ترفض ممارسة هذا الطقس تحدثت قائلة: «هذه الظاهرة كانت مرتبطة بالجهل وقلة الوعي الديني فمن كان بريئاً من هاتين الصفتين كان يقف موقفاً سلبياً من شموع الخضر
ومن الجدير بالذكر أن هنالك أناشيد معينة كانت ترتبط بهذه الظاهرة منها ما ذكره لنا الباحث غسان رمضان:
آني نذرن عليا/ أطوف شموع بميا
ينظرني الرايح والجاي/ كله علشانك يا هواي
وأعطي للي يراضينا/ هالخاتم البديا.
الفرات