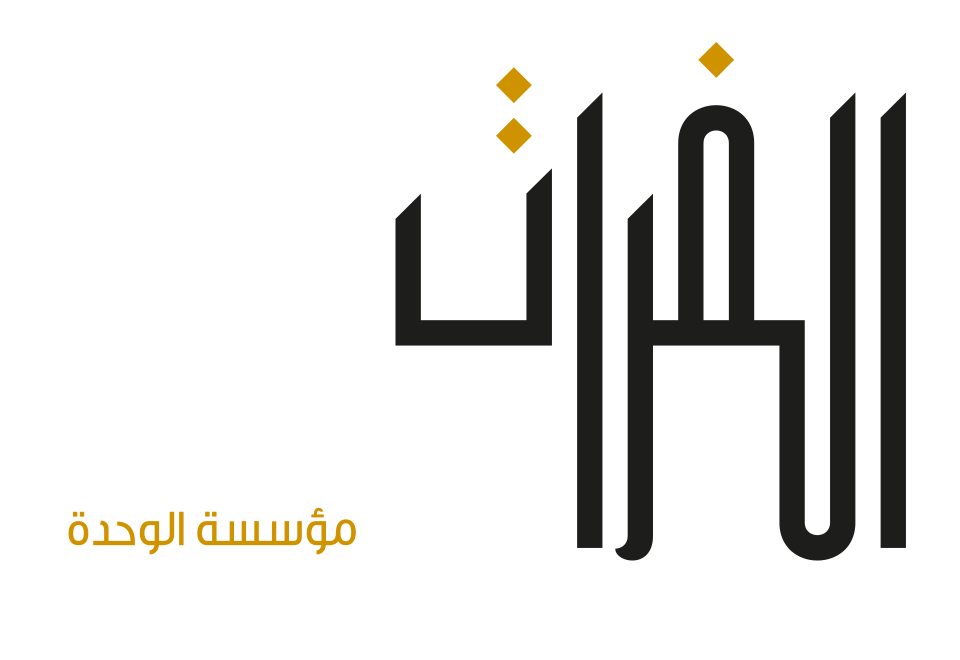لم أشأ أن أحدثه ، عندما جلست جانبه على ذاك الرصيف في شارع التكايا ، المطل على أقدم حيين من أحياء المدينة ( الحميدية والشيخ ياسين )
رجل سبعيني ملامحه تماهت مع ذقنه وشعره الأبيض ، تتسامى في عينه أفق يمتد لطرفي الشارع وربما يمتد عميقاً في ذاكرته .
سيكارته التالية كانت أكثر كثافة في ضبابيتها من سابقتها ، لعل أنفاسها كانت عميقة .
ودون أن أساله تحدث : رغبتك تدفعك بالبحث عن بقية باقية من رائحة المكان من أثر اﻷهل واﻷحبة ، في مدينة أدمنت أهلها وأدمنها محبوها ، ليس هناك شيءٌ يدفعك للبقاء ، حتى الحجر كاد أن يبحث عن فرصة للهروب
مشيراً بيده … ما عاد هذا الرصيف يعرف وقع خطى المحبين، كلهم قد رحلوا وتركوا كل شيء .
تبدّل كل شيء ، كل شيء ، أنت هنا لتبحث – أعرف ذلك – مدينة رحل أهلهوها هجروها، و محبوها جفوها.
دير الزور بساطة هي حكاية رصيف ، لاتستغرب من كلامي ، لم يعرف رصيف في هذه المكان الفراغ ، بل كان مشغولاً … المقاهي … المطاعم … الدكاكين … المحلات … سهرات الجيران فيما بينهم وصباحاتهم .. لقاهم الدائم على الرصيف موعد يحرص على تلبيته كل أبناء المدينة .
لعب الصغار … وضحكات الشباب .. كلها كانت على هذا الرصيف .
كنت تقطع هذا الشارع تلتقي فيها بكثير ممن تعرفهم، ويدك تمدها بين تلقي التحية أو تردها .
بني تم اغتيال الفرح من داخلنا … تدرك ذلك أعلم أنك تدركه تماماً ! لاشيء يزدحم في ذاكرتي سوى الرصيف .
كل شيء في بدا غريباً … مبهماً
الوجوه، اللباس حتى اللغة ولهجتنا ومذاق رغيف الخبز والملح الذي فسد. حتى هذا الحجارة المتراكمة تبدلت؛ بالرغم من صمتها، تحدثك عن كل لحظات اﻷسى والجرح وضياع التاربخ والذكريات.
الرصيف حكاية وحدها ، لكن أين هو الآن … لايدرك معناه إلا من عاشه ، لاشيء يزدحم في ذاكرتي سوى الرصيف .
ربما يدهشك كلامي ، فما زالت ذاكرته داخلي ، تسكن ذكريات عشتها وعاشها أغلب أبناء الدير ، ولابدّ من مخاطبة محتواهم ففيها الذاكرة التي نعرفها لنهرب بها من وجع الحاضر
اتجاهات المدينة لم تتبدل … شرقها كغربها وشمالها كجنوبها، لكن بيوتاً هوت وافرغت من قاطنيها وحجارة فقدت ذاكرتها ورصيف لم يعد يطيق المارة والعابرين.
لا شيء سوى الحزن، ولم يعد للفرات الصيغة التي نعرفه بها ، ذاك النهر الذي شهد على كل شيء ، اليوم يجري دون أن يلتفت إلينا .
يومياً هاهنا ، ستجدني باستمرار ، لاتغب عنّي طويلاً ، كن بخير !ّ
خالد جمعة