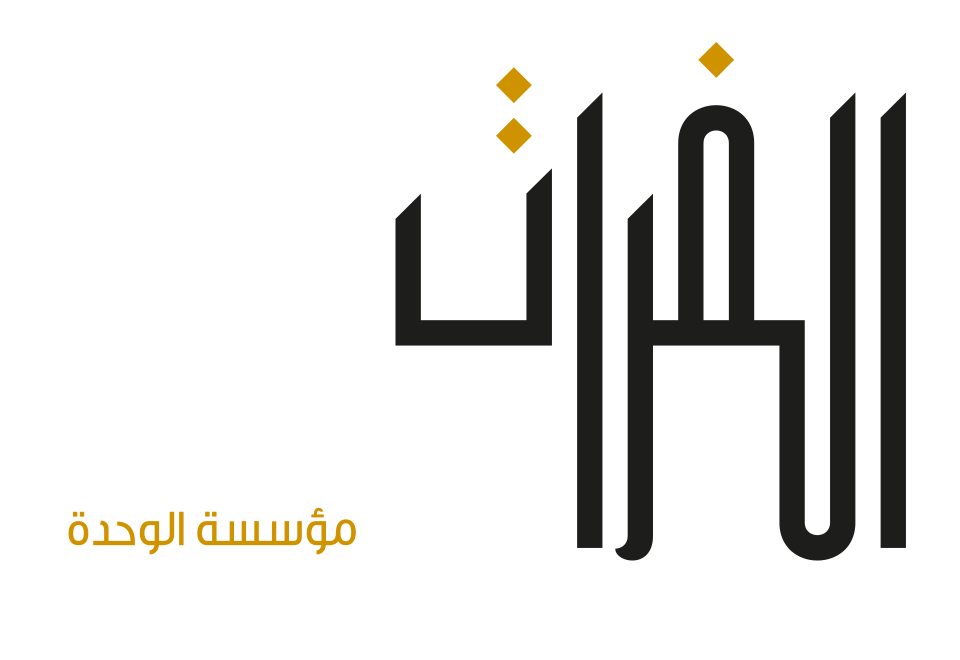لن نجد مدخلاً للحديث عن الأديب الطبيب الراحل عبد السلام العجيلي أفضل من وصف الشاعر الكبير نزار قباني له بأنه “أروع بدوي عرفته المدينة وأروع حضري عرفته البادية” وبأنه “أهم أديب وكاتب قصة في بلادنا”.
ثناء نزار على أديب بقيمة العجيلي لم يكن الأول ولا الأخير من طرف طبقة كبار المبدعين فالأديب المصري يوسف إدريس وصف ابن مدينة الرقة بأنه “رائد القصة العربية القصيرة بلا منازع” أما الناقد الأردني محمد عبيد الله فيؤكد أنه “ليس هناك كاتب عربي بمستوى قصص العجيلي القصيرة فهو رائع فيها إلى حد كبير”.
وسنترك المجال لأديبنا الراحل ليروي لنا سيرة حياته كما سجلها هو في حوار صحفي أجري معه قبل رحيله ببضعة أعوام حيث يخبرنا أنه ولد في مدينة الرقة سنة 1918 وكانت حينها بلدة صغيرة حيث حمله والده وهو طفل رضيع إلى رجل دين اسمه عبد الرحمن الحجار والذي أطلق عليه اسم عبد السلام حتى يسلمه الله.
تعلق العجيلي بالأدب بدأ معه منذ سن صغيرة فكان مغرماً بالمطالعة وكان يقرأ بشغف كل ما يقع تحت يده في بلدته والتي كانت محصورة في الكتب الدينية بأنواعها والسير الشعبية كعنترة وحمزة البهلوان وألف ليلة وليلة ورغم أن هذه الكتب لم تكن هي التي جعلت منه أديبا ولكنها كانت الأساس لموهبته حين خرجت إلى الإنتاج والإبداع.
وحين انتقل العجيلي من الرقة إلى مدينة حلب ليتابع دراسته الثانوية في مدرسة التجهيز الثانوية أتيحت له مصادر قراءة أخرى فقرأ الأدب العربي وترجمات القصص والروايات من اللغات الأجنبية وحينما تعلم اللغة الفرنسية صار يفضل قراءة الأعمال فيها.
وأخذ العجيلي ينشر أثناء دراسته الثانوية قصصاً وقصائد باسم مستعار وظل هذا دأبه لسنوات طوال من عمره حتى أنه استعمل 22 اسماً مستعاراً ما يدل على زهده بالشهرة وكانت أول قصة نشرها وهو في السادسة عشرة عن حادثة تقع لبدوي قاطع طريق صدرت في مجلة الرسالة المصرية بتوقيع (ع من حلب).
وعندما نال العجيلي الشهادة الثانوية انتقل إلى دمشق ليدرس في جامعتها الطب البشري وهنالك اتيح له المجال لبناء صداقات استمرت طيلة حياته مع كبار أعلام الأدب والصحافة وانخرط بقوة في العمل الطلابي فكان رئيساً للجنة الطلابية وساهم بتأسيس عصبة الساخرين سنة 1948 التي كان رئيسها وضمت مجموعة من كبار الأدباء أمثال عبد الغني العطري وسعيد الجزائري وحسيب كيالي وآخرين.
العجيلي الذي أصدر أول كتبه وكانت مجموعة قصصية بعنوان بنت الساحرة وهو في الثلاثين من العمر عاد إلى مدينته بعد تخرجه ليفتتح عيادة يداوي بها أبناء تلك المحافظة مترامية الأطراف والتي كانت تقارب في مساحتها مملكة بلجيكا كما كان يقول.
انخراط العجيلي بالشأن العام واهتمامه الشديد بقضايا الناس والأمة جعلاه يقدم على خطوتين أثرتا على تجربته الأدبية فترشح للانتخابات النيابية عن منطقته سنة 1947 وأصبح أصغر عضو في مجلس الشعب ثم تطوع للقتال ضد العصابات الصهيونية مع جيش الانقاذ سنة 1948 حيث سيتحدث عن هذه المرحلة لاحقاً في قصصه كما في (كفن حمود) و(بنادق في لواء الجليل).
ولكنه سيصف لاحقاً تجربته في العمل السياسي بالمثبطة بالنسبة له لأنه وجد فيها تناقضاً بين قناعاته وبين التزامه بمصالح من ترشح باسمهم ومع ذلك استدعي للمشاركة في الحكومات التي شكلت عقب انفصال الوحدة بين سورية ومصر وأصبح وزيراً للخارجية والثقافة والإعلام.
استقراره في الرقة وعمله فيها كطبيب لم يمنعه من السفر المستمر فهو طاف أرجاء الأرض كما كان يقول وكانت مشاهداته من بيئته التي تجمع البداوة والريف وترحاله المستمر أكبر زوادة له في صناعة أدبه.
كان العجيلي يؤمن بأن الموهبة والفطرة وحدهما لا تكفيان لصناعة الأديب بل يجب أن يكون أكثر قدرة على الملاحظة ورؤية ما لا يراه ولا يستشفه الآخرون.
ورداً على وصف بعض النقاد لأعماله بأنها تكرس مفهوماً سياحياً في الأدب كان يرى أن عنده كتابات كثيرة في أدب الرحلات ولكن هذه الرحلة تعيده دائماً لمنبته الأول مثل قصة ساري المنشورة ضمن مجموعته قناديل إشبيلية وترجمت للإيطالية والفرنسية والسويدية وتروي حكاية شاب بدوي يتعرض لمغامرة جرت له في مدينة أوبسالا شمال السويد ولكن تسلسل الأحداث يعيده لمضارب أهله في الجزيرة.
وكان لافتاً أن العجيلي ظل يصر على عدم منح الأدب من نفسه وحياته أكثر مما فعل وكان يضع نفسه في حقل الأديب الهاوي ويفضل أن يطلق عليه صفة الطبيب على صفة الأديب.
ويقول في هذا الصدد الباحث الدكتور علي القيم صديق الراحل في كتابه “الدكتور عبد السلام العجيلي جوهرة الفرات”.. “لقد اتخذ العجيلي الأدب متعة مجردة منذ بدايات حياته الحافلة بالعطاء وكانت مدينة الرقة حاضرة في أكثر كتاباته فسجل عنها وعن أهلها حكايات وروايات ومقالات ومحاضرات كثيرة كما في كتابه عيادة في الريف الذي كان تدويناً لحكايات صادقة بمضحكاتها ومؤسياتها فجاء تعبيراً عن البيئة التي أقام بها”.
العجيلي كان غزير الإنتاج فصدر له 40 كتاباً 7 في الرواية و13 في القصة و19 في أدب الرحلات والملاحظات الاجتماعية والسياسية والسيرة الذاتية وديوان في الشعر وترجم الكثير من كتبه إلى 14 لغة أجنبية كما تفرد أيضاً بأدب المقامات حيث كانت لغته فيها ساخرة ضاحكة.
ولأن أديبنا الراحل ابن بيئته بحقه وارتباطه بالموروث واضح لا لبس فيه فإنه أول من زاوج بين الحكاية والقصة من كتابنا المعاصرين وفقا للأديب وليد إخلاصي فكان في حكاياته متعددة الوجوه مؤسساً فاعلاً لبنية الأدب العربي الحديث.
ولتحديد حجم تماهي العجيلي مع الواقع ننقل عنه خلال حديث أدلى به لمجلة العربي الكويتية بأنه وضع مرة في إحدى قصصه اسماً لشارع في العاصمة البريطانية لندن وحين تبين له عدم وجود هذا الشارع شعر بأسى كبير لقد كان يقول “إنني صادق مع حرفي.. والصفاء رسالتي”.
وخلافاً للكثير من أدباء العصر الحديث كانت قصص العجيلي ورواياته زاخرة بالفرح كما يؤكد الأديب محمد قرانيا وكانت خالية من الموضوع المأساوي النابع من إحساس المبدع تجاه الحياة الراهنة بكل أحداثها.
لقد فضل العجيلي العيش في الرقة على سواها ولكنه من قلب هذه المدينة ومن عيادته الصغيرة بلغ ذرا الشهرة والمجد غير أنه لم يحفل بكل ذلك بل كانت كتبه تحمل اسمه إلى الآفاق وهو منكب على علاج مرضاه الذين كان لا يتقاضى من أغلبهم أي أتعاب شأنه في ذلك شأن صديقه الشاعر الحموي وجيه البارودي.
امتد العمر بالعجيلي وودع الكثير من أصدقائه الذين سبقوه لعالم الخلود حتى أنه ألف كتاباً يعد من أجمل ما كتب في أدب الرثاء المعاصر هو “وجوه الراحلين” وقال للصحفية سعاد جروس “لقد شبعت من الحياة عشتها بكل ما فيها وما عدت أرغب في المزيد” لتكون زيارته لدمشق عام 2005 هي الأخيرة له حيث تلقى وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.
وبعد أن توقف عن معالجة المرضى في عيادته وترك هذه المهنة لابنه الطبيب حازم اشتدت آلامه وأعراض المرض عليه فجلس في بيته يتلقى اتصالات الأصدقاء والمعجبين وزيارات المحبين حتى وافاه أجله في يوم الأربعاء 5 نيسان من سنة 2006 وكان لافتاً أنه لحق بالأديب الكبير محمد الماغوط بعد وفاته بيومين.
لقد ترك لنا العجيلي الكثير ولكن له عبارة خليق بنا أن نستذكرها وأن نعمل بها في وجه ما يطالنا من ظروف عندما قال وكأنه يخاطبنا اليوم “نحن السوريين علينا واجب أن نعود إلى أنفسنا لنتلمس فيها الغنى والقوة والصمود”.