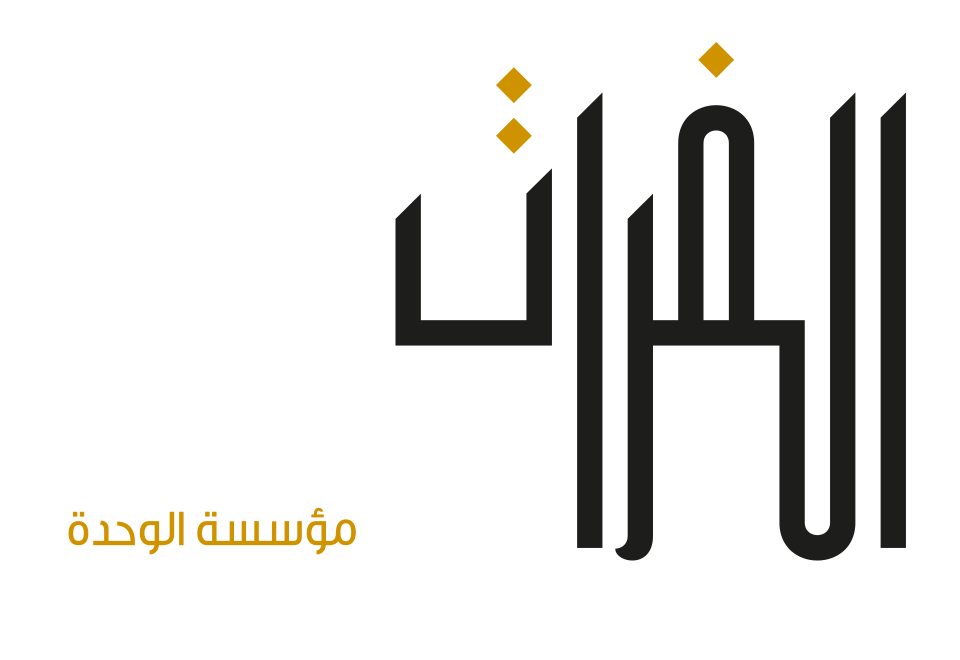في زاوية من إحدى الدوائر الحكومية بالحسكة وقف موظف خمسيني يروي بابتسامةٍ ممزوجة بشيء من الألم والرضا، كيف كان راتبه قبل شهرين لا يتجاوز 40 دولاراً شهرياً، مبلغ بالكاد يغطي أجرة مواصلاته للعمل، وفي بعض الأيام—كما يقول— كان يضطر للعودة إلى بيته مشيًا على الأقدام بعد أن “تطير” مخصصات اليوم على سندويشة أو حاجة بسيطة.
اليوم، بعد أن وصلت الزيادة التي أقرها السيد الرئيس أحمد الشرع والتي نصّت على رفع الأجور بنسبة 200%—يقول هذا الموظف بثقة: “الفرح عاد إلى بيتنا، لأول مرة منذ سنوات أشعر أنني قادر على سداد ديوني، ويمكن أن أشتري شيئاً إضافيًا لأطفالي دون أن أرتجف قبل كل شراء”.
الزيادة التي طال انتظارها، شكّلت بارقة أمل لدى كثير من العاملين في القطاع العام، وأعادت إلى الأذهان وعود الدولة المتكررة بتحسين الوضع المعيشي للموظفين، الذين لطالما كانوا على هامش السياسة الاقتصادية، رغم كونهم المحرّك الفعلي لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
لكن، وبعيدًا عن لحظة الفرح الأولى، تبقى الأسئلة الكبرى معلّقة:
هل الزيادة كافية في ظل الغلاء الجنوني الذي تشهده الأسواق؟
هل ترافقها إجراءات رقابية تمنع ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي بمجرد إعلان زيادة الرواتب؟
وهل هناك خطط طويلة الأمد تضمن أن لا يعود راتب الموظف مجددًا إلى خانة “لا يكفي لثمن الخبز”؟
الموظف السوري لم يكن ينتظر أن يصبح غنيًا، كان يحلم فقط بكرامة يومية، بأجر يحفظ له ماء وجهه أمام أسرته، ويجنبه ذل الديون.
والآن، بعد الزيادة، بدأ الحلم يتحقق، ولو جزئيًا. المهم أن يكون بداية لسياسة اقتصادية شاملة تنظر إلى الموظف كمحور للإنتاج لا كرقم في موازنة.
زيادة الرواتب خطوة أولى صحيحة، لكنها بحاجة لخطوات أُخرى تُوازيها في ضبط الأسعار، وتحفيز الإنتاج، وتقوية الليرة. فالموظف السوري يستحق أكثر من الفرح المؤقت… يستحق مستقبلًا يمكنه أن يخطط له دون خوف
حجي المسواط