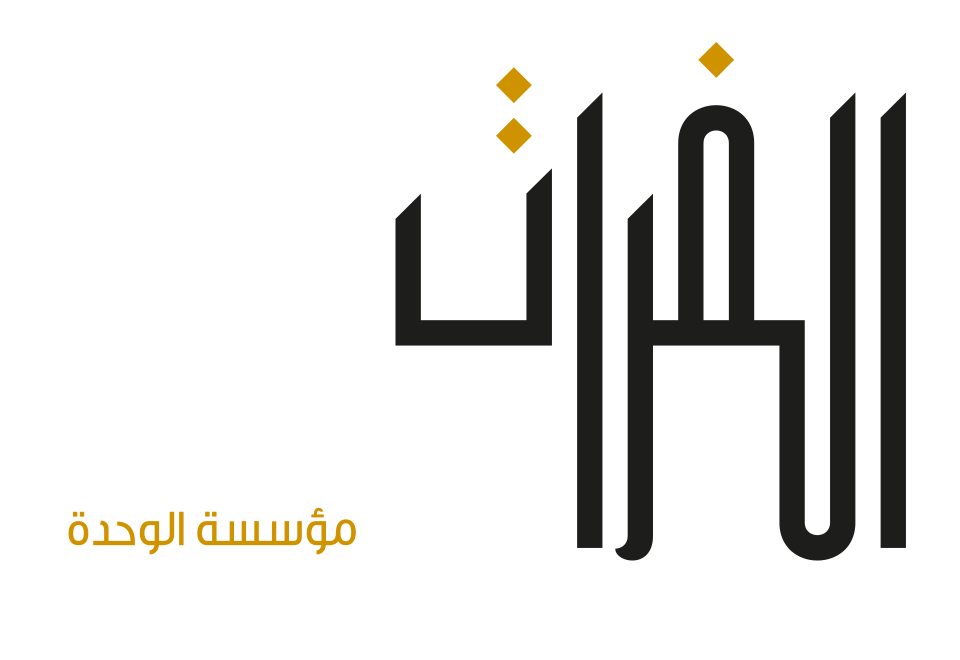القصة الفائزة بالجائزة الذهبية عن فئتها بمسابقة “حكايتي” لـ #مؤسسة_وثيقة_وطن للزميل الصحفي ” فراس القاضي ” ابن محافظة دير الزور .
لا أستطيع في العاشر من تموز، ألا أتذكر تفاصيل هذا اليوم من عام 2015، يوم خروجنا من حصار دير الزور مقهورين جائعين مخذولين حزانى على حياتنا وعلى بلد علمنا أننا قد لا نعود إليه. في مثل هذا الوقت؛ في العاشرة مساءً، كنّا في المطار العسكري، وأصوات القذائف والصواريخ وطائرات الميغ تصم الآذان ثم تختفي، ننتظر طائرة الأنتينوف القادمة من دمشق، ولا نعرف ما الذي سيحصل، هل سننجو ونشبع بعد جوع ونأمن بعد خوف؟ أم سنبقى هنا؟
كنا جميعاً؛ كل المدنيين الذين ينتظرون طائرة الهروب من الموت جوعاً، نجلس على حقائبنا، كان عمر نادين ابنتي ثلاث سنوات، وكانت نائمة في حضن والدتها، تصحو كل عشر دقائق أو ربع ساعة، تبكي وتقول: أريد تختي.
في تلك اللحظات كنت أستجمع كل ما تبقى من قوتي لأختلط بالموجودين، وأحاول فتح أحاديث معهم لكسر حالة الوجوم والخوف الذي نعيشه جميعاً، مضافٌ إليها حالة شعور بالذل انتابتني، ولا أذكر أنني شعرت بالإذلال خلال عمري بأكمله، نعم كان ذلاً حقيقياً.

كان عمر ابني كريم خمس سنوات ونصف، ينتقل من حضن أمي إلى حضني، ثم يركض حولنا، ثم يعاود الجلوس، يمسح بعينيه المكان والناس والسيارات والدبابة التي دخلت خلال وجودنا، ودون مبرر سألني أكثر من مرة: بابا.. ما عاد نرجع عالدير؟
كان هذا ثاني أصعب سؤال أتعرض له خلال حياتي، لأن السؤال الأصعب كنت أسأله لنفسي طوال تلك الأيام: أيهما أقوى؟ الوطن والأرض.. أم الجوع؟
وفجأة، في الواحدة بعد منتصف الليل تماماً، كسر هذا الجو القاتل صوتُ أحد جنود المطار يقول: يالله هانت.. طلعت الطيارة من الشام.
كلنا سمعنا أن الطائرة تحتاج إلى خمسين دقيقة حتى تصل إلى المطار، لكننا سألنا جنود المطار مئات المرات: مطولة الطيارة؟ جاية الطيارة؟ ممكن تنلغى الرحلة؟
للأمانة، كانت صدورهم واسعة جداً مع المدنيين، وكان جوابهم تقريباً موحداً: (يالله ليكا رح توصل.. بس ممكن ما تهبط إذا كان فيه ضرب عالمدرج متل مبارح).
الجملة الأولى كانت تحيينا، والثانية تقتلنا.
وفي الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل، وصل ضابط أمن المطار ليعطينا تعليمات الصعود إلى الطائرة، وكانت:
(ربع ساعة وبتوصل الطيارة، بنفرغ حمولتها وبعدين بتطلعوا فيها كالتالي: بتمشوا ورا العسكري اللي رح ياخدكن.. بتمشوا ورا بعض.. واحد واحد ورا بعض.. لا حدا يتشاطر.. اللي بيدفشه هوا المحركات أو بيشفطه بيروح من كيسه.. برجع بقول لا حدا يتشاطر ويحاول يركض لحاله أو يلتف عالمجموعة.. يالله جهزوا حالكن.. بدنا نمشي فوراً لأنو المدرج بعيد.. اذا بدكن فيه سيارة خضروات فايتة لجوا.. اطلعوا معهن).
هنا بدأ فصل عذاب جديد، بدأت أنظر إلى الخلف، أنظر إلى دير الزور، إلى أبي الذي رفض السفر دون لوحاته التي يحبها كما يحبني ويحب أخي أمجد، ورجانا بأن نتركه فيها ريثما يستطيع تأمين سفر له ولها.. بيتي.. مكتبي.. حديقة أهلي.. شوارعي.. عودي.. جريدتي.. ذكرياتي وعمري.
لكن الجوع أقوى، نعم كان أقوى، حملت الحقائب مع خالي، ورفعناها إلى سيارة الخضار، وأجلسنا أمي بجانب السائق لأنها لا تقوى على تسلق سيارة نقل كبيرة، وركبنا جميعاً في الخلف وانطلقنا إلى المدرج.
لن أنسى ما حييت كيف شهقنا جميعاً وتعلقت أبصارنا بالسماء حين سمعنا هدير الطائرة، والجميع يكرر: وصلت وصلت وصلت.
هبطت الطائرة، ولم تطفئ محركاتها، لأنها وفي حال تم قصف المدرج من قبل الدواعش، فإن الكابتن مزوّد – حسبما روى لنا الجنود – بأمر الإقلاع فوراً حتى لو لم يتم إفراغ كامل الحمولة.
هدير الطائرة وصوتها العالي جداً جداً منعنا من سماع بعضنا البعض، وقفنا كما قيل لنا، واحد ورا واحد، استمر وقوفنا حوالي 20 دقيقة أو أكثر قليلاً على باب المدرج ريثما تم تفريغ الحمولة التي كانت عبارة عن طعام وذخائر، وجاء الأمر من ضابط الأمن: بسرعة عالطيارة.. يا الله تلك اللحظة، قلوبنا تسبق أرجلنا، كنت أجرّ حقيبة كبيرة جداً، وأضع حول عنقي حقيبة اللابتوب، وحقيبة أخرى في الجهة الثانية فيها أوراق مهمة، أمي محنيّة الظهر، كانت تحمل حقيبة خفيفة وتمسك كريم من يده، زوجتي تحمل نادين بيد، وتدخل يدها بحقيبة جر حتى الكوع، وكفها يمسك كريم من ياقته، خالي جورج يحمل حقيبتين كبيرتين، تلك الحقائب كانت كل ما بقي لنا من حياة عمرها 40 عاماً، نسير بثقل شديد بسبب هواء المحركات القوي جداً والساخن جداً.. سقط أكثر من شخص في الطريق إلى الطائرة، ولم نحاول كمدنيين مساعدتهم، نعم أعترف أن غريزة البقاء كانت أقوى من كل شيء في تلك اللحظات، لكن جنود المطار لم يتركوهم، وركضوا وحملوا كبار السن إلى الطائرة.
مدخل الطائرة ليس درجاً يصعد إليها كما سيتوقع البعض، بل هو الباب الخلفي (الرمبة)، وكانت (الرمبة) ملساء جداً.
وصلنا.. صعد الكبار وساعدناهم، صعد الجميع، بقينا أنا وخالي وشاب ورجل كبير آخر الصاعدين، وكلما حاولت الصعود، سحبني ثقل الحقيبة الكبيرة إلى الأسفل، يساعده حذائي الرياضي الأملس من الأسفل أيضاً. محاولة، اثنتان، ثلاثة ولم أدخل إلى الطائرة.
فظهر فجأة أعلى الباب، ثلاثة جنود أو أربعة، مع كابتن الطيارة، ضابط برتبة مقدم، ضخم البنية خشن الملامح وقال: (أكتر من هدا العدد ما فينا نطالع، مشان سلامتكن وسلامتنا.. انتو للطيارة الجاية)، أيضاً لن أنسى ما حييت مشاعري في تلك اللحظة، طيارة جاية؟ وإن لم تصل الطيارة الجاية ماذا سنفعل؟
بدأنا نصرخ ونتوسل، الكل قال له بأن عائلاتنا صارت في الطائرة، وأصر الكابتن على عدم صعودنا، حتى أن الشاب الذي كان بجانبنا وصل ومنعه الكابتن من الدخول، توسلنا أكثر، وكان يجيبنا بأن الطائرة لا تحتمل كل هذا الوزن، وعلينا أن ننتظر فربما يعود بعد ساعتين، لكن كيف ستقنع غريقاً يتمسك بقشةٍ بأن يتركها وينتظر غيرها؟
توسلنا أكثر، فنظر إلى الجنود الذي يقفون بقربه، لم ينطقوا، لكن عيونهم كانت تقول له: اسمح لهم بالصعود، فنظر إلينا وقال اطلعوا.
صعد الثلاثة، وبقيت وحدي، فقواي خارت تماماً بعد أن قال لنا (انتو للطيارة الجاية) وبان عليّ تعب وجوع سبعة أشهر، والحقيبة التي كنت أجرها أثقل مني، فقد كان وزني عندما وصلنا إلى دمشق ليلتها 46 كيلو غرام فقط، حاولت الصعود وفشلت، وحاولت وفشلت بالتقدم سنتيمتر واحد، فأمسك الكابتن يد أحد الجنود في الأعلى، وخطا خطوتين باتجاهي، وأمسكني من كتفي وسحبني أنا والحقيبة إلى الطائرة.. وأغلقوا الباب، وبدأ الجنود يدفعوننا بكل قوتهم إلى الأمام ويصرخون بنا: (تحركوا تحركوا لازم تتوازن الطيارة) تحركت الطائرة، وكان إقلاعاً سلساً بشكل مذهل، ولم نشعر أبداً أن الطائرة قد ارتفعت.. وارتفعت.
كان من المفروض أن تكون مدة الطيران إلى دمشق 50 دقيقة، لكن الحمل الزائد أضاف إليها 40 دقيقة أخرى، كل واحدة منها تعادل عمراً بأكمله.
الطائرة مظلمة جداً، وممنوع منعاً باتاً إشعال أي ضوء مهما كان خافتاً، حتى أن شخصاً أضاء جهازه الخليوي ربما ليرى كم الساعة، فنال من الشتائم والصراخ ما يكفيه ثلاثة أعمار.
كانت الحرارة داخل الطائرة تتجاوز الخمسين درجة بكل تأكيد، لأن العرق لم يكن يقطر مني، بل يسيل بغزارة، وكانت وضعيتي هي منبطحاً فوق الحقيبة الكبيرة في مكان ما من الطائرة لا أعرفه، ومثلي مثل البقية، لا أعرف أين أمي ولا أين عائلتي ولا أين أنا، فالظلام أحلك بكثير من أن ترى شيئاً، أي شيء.
بعد أكثر من نصف ساعة، اشتعلت الأضواء داخل الطائرة، وبدأ الجميع يبحثون عن ذويهم، والطائرة لها مقعدان من حديد متقابلان، يمتدان من أولها إلى آخرها وليس مقاعد منفردة كالطائرات المدنية، فكانت الملاحظة الأولى أن كل المحجبات قد خلعن الحجاب من شدة الحرارة، والملاحظة الثانية أن كل الجنود كانوا في الممر بين الحقائب لأنهم أجلسوا المدنيين على كرسي الحديد. بدأت أبحث عن أمي وعائلتي لكن الازدحام كان شديداً، ثم عرفت مكانهم عندما صرخت أمي المهووسة بمحبة هذا الجيش: الله محيي الجيش.
وكي لا تكون كل أجزاء الرحلة مأساوية، إليكم هذا الفصل الكوميدي، أو الذي صار كوميدياً الآن، وليس وقتها بكل تأكيد.
اشتعلت الأضواء، سمعت صوت أمي، ثم رأيتهم جميعاً من بعيد، تنفست الصعداء قليلاً، نظرت بقربي، وإذ بجندي صغير العمر وصغير الحجم جداً، وكأنه طالب إبتدائي تطوّع في الجيش، ضائع داخل بزته العسكرية المموهة، وكان واضحاً جداً أن تلك الرحلة هي رحلته الأولى بالطائرة، فنظر إلي وقال وهو دامع العينين: (هلأ بيضربونا وبيسقطوا الطيارة)!
أطفئت أنوار الطائرة مرة أخرى، فقال لي: (شفت؟ الطيار عم يموّه مشان ما يصيبونا)!
لا حول ولا قوة الا بالله.. طبعاً أنا دخلت فوراً بالمفاضلة التالية: أيهما كان أفضل: أن نموت جوعاً أم بسقوط طائرة؟
أنيرت الأضواء، فخرج جندي من قمرة القيادة وصرخ بأعلى صوته: (عطوني أكبر شنتاية بالطيارة)، وكان أحد الركاب معه حقيبة لم أر في حياتي أكبر منها، فأوصلوها إلى الجندي، الذي وضعها فوق ما يشبه فتحة الراكارات التي نراها في الشوارع، وقال لشاب سمين: (تعال قعود فوقها).
فقال لي: (شفت؟ شفت؟).
لم أجبهُ، ولم أناقشه بشيء، اكتفيت بالنظر في عينيه الراجفتين، حزنت عليه صدقاً، كان صغيراً وطرياً جداً.. ذكرّني بكريم.
عند الثالثة والربع تقريباً، بدأت أنوار دمشق تظهر لنا من بعيد عبر نوافذ الطائرة.. يا الله.. يا الله الشام يا الله.. يا الله الشام مافي دواعش وجوع هون.. يا الله الشام الشام، واختلط العرق بالدموع بالابتسامات بالتهاني، لكن الجميع كانت وجوههم ما يزال عليها شيئاً من الخوف.
في الثالثة والنصف بعد منتصف الليل تماماً، شعرنا باحتكاك إطارات الطائرة بالأرض، ثم بوقوفها داخل مطار دمشق الدولي القسم العسكري، وكنا جميعاً ننظر إلى بعضنا، ثم أطفأ الكابتن المحركات، وخرج وقال لنا: (الحمد لله عالسلامة)، فانفجر المدنيون جميعاً بالبكاء، ووالله ما عدت أذكر من عانقني وعانقت مَن.
نزلنا.. ودعنا بعضنا بنظرات خجولة.. مررنا على التفتيش والتفييش.. استقلينا سيارة أجرة إلى بيت استأجره أخي لنا قبل أن نصل بأسبوع في ضاحية قدسيا.. استقبلتنا اثنتان من خالاتي وأولادهم.. بكوا كثيراً على سواد وجوهنا ونحولنا المخيف وانحناء ظهر أختهم القوية العظيمة.. دخلنا إلى المطبخ.. ورأينا الطعام مكدساً بالأكوام.. خجلنا من الذي بقيوا هناك.. من أبي الذي لحق بنا بعد شهر بما تيسر له من لوحات استطاع حملها، وترك البقية (450 لوحة) لتأكلها نيران الصاروخ الذي انفجر داخل منزلنا.. خجلنا من أصدقائنا الذين في تلك الليلة التي شبع بها أولادي نام أولادهم جوعى.. من كل شيء.. من مقابض الأبواب الجديدة التي استغربت لمساتنا واستغربنا ملمسها.. من حديقة لا تشبه حديقتنا وورودها.. من ماءٍ ليس فراتاً.. لكننا نجونا.
.
” الهجرة من الموت إلى الحنين ”
لا أستطيع في العاشر من تموز، ألا أتذكر تفاصيل هذا اليوم من عام 2015، يوم خروجنا من حصار دير الزور مقهورين جائعين مخذولين حزانى على حياتنا وعلى بلد علمنا أننا قد لا نعود إليه. في مثل هذا الوقت؛ في العاشرة مساءً، كنّا في المطار العسكري، وأصوات القذائف والصواريخ وطائرات الميغ تصم الآذان ثم تختفي، ننتظر طائرة الأنتينوف القادمة من دمشق، ولا نعرف ما الذي سيحصل، هل سننجو ونشبع بعد جوع ونأمن بعد خوف؟ أم سنبقى هنا؟
كنا جميعاً؛ كل المدنيين الذين ينتظرون طائرة الهروب من الموت جوعاً، نجلس على حقائبنا، كان عمر نادين ابنتي ثلاث سنوات، وكانت نائمة في حضن والدتها، تصحو كل عشر دقائق أو ربع ساعة، تبكي وتقول: أريد تختي.
في تلك اللحظات كنت أستجمع كل ما تبقى من قوتي لأختلط بالموجودين، وأحاول فتح أحاديث معهم لكسر حالة الوجوم والخوف الذي نعيشه جميعاً، مضافٌ إليها حالة شعور بالذل انتابتني، ولا أذكر أنني شعرت بالإذلال خلال عمري بأكمله، نعم كان ذلاً حقيقياً.
كان عمر ابني كريم خمس سنوات ونصف، ينتقل من حضن أمي إلى حضني، ثم يركض حولنا، ثم يعاود الجلوس، يمسح بعينيه المكان والناس والسيارات والدبابة التي دخلت خلال وجودنا، ودون مبرر سألني أكثر من مرة: بابا.. ما عاد نرجع عالدير؟
كان هذا ثاني أصعب سؤال أتعرض له خلال حياتي، لأن السؤال الأصعب كنت أسأله لنفسي طوال تلك الأيام: أيهما أقوى؟ الوطن والأرض.. أم الجوع؟
وفجأة، في الواحدة بعد منتصف الليل تماماً، كسر هذا الجو القاتل صوتُ أحد جنود المطار يقول: يالله هانت.. طلعت الطيارة من الشام.
كلنا سمعنا أن الطائرة تحتاج إلى خمسين دقيقة حتى تصل إلى المطار، لكننا سألنا جنود المطار مئات المرات: مطولة الطيارة؟ جاية الطيارة؟ ممكن تنلغى الرحلة؟
للأمانة، كانت صدورهم واسعة جداً مع المدنيين، وكان جوابهم تقريباً موحداً: (يالله ليكا رح توصل.. بس ممكن ما تهبط إذا كان فيه ضرب عالمدرج متل مبارح).
الجملة الأولى كانت تحيينا، والثانية تقتلنا.
وفي الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل، وصل ضابط أمن المطار ليعطينا تعليمات الصعود إلى الطائرة، وكانت:
(ربع ساعة وبتوصل الطيارة، بنفرغ حمولتها وبعدين بتطلعوا فيها كالتالي: بتمشوا ورا العسكري اللي رح ياخدكن.. بتمشوا ورا بعض.. واحد واحد ورا بعض.. لا حدا يتشاطر.. اللي بيدفشه هوا المحركات أو بيشفطه بيروح من كيسه.. برجع بقول لا حدا يتشاطر ويحاول يركض لحاله أو يلتف عالمجموعة.. يالله جهزوا حالكن.. بدنا نمشي فوراً لأنو المدرج بعيد.. اذا بدكن فيه سيارة خضروات فايتة لجوا.. اطلعوا معهن).
هنا بدأ فصل عذاب جديد، بدأت أنظر إلى الخلف، أنظر إلى دير الزور، إلى أبي الذي رفض السفر دون لوحاته التي يحبها كما يحبني ويحب أخي أمجد، ورجانا بأن نتركه فيها ريثما يستطيع تأمين سفر له ولها.. بيتي.. مكتبي.. حديقة أهلي.. شوارعي.. عودي.. جريدتي.. ذكرياتي وعمري.
لكن الجوع أقوى، نعم كان أقوى، حملت الحقائب مع خالي، ورفعناها إلى سيارة الخضار، وأجلسنا أمي بجانب السائق لأنها لا تقوى على تسلق سيارة نقل كبيرة، وركبنا جميعاً في الخلف وانطلقنا إلى المدرج.
لن أنسى ما حييت كيف شهقنا جميعاً وتعلقت أبصارنا بالسماء حين سمعنا هدير الطائرة، والجميع يكرر: وصلت وصلت وصلت.
هبطت الطائرة، ولم تطفئ محركاتها، لأنها وفي حال تم قصف المدرج من قبل الدواعش، فإن الكابتن مزوّد – حسبما روى لنا الجنود – بأمر الإقلاع فوراً حتى لو لم يتم إفراغ كامل الحمولة.
هدير الطائرة وصوتها العالي جداً جداً منعنا من سماع بعضنا البعض، وقفنا كما قيل لنا، واحد ورا واحد، استمر وقوفنا حوالي 20 دقيقة أو أكثر قليلاً على باب المدرج ريثما تم تفريغ الحمولة التي كانت عبارة عن طعام وذخائر، وجاء الأمر من ضابط الأمن: بسرعة عالطيارة.. يا الله تلك اللحظة، قلوبنا تسبق أرجلنا، كنت أجرّ حقيبة كبيرة جداً، وأضع حول عنقي حقيبة اللابتوب، وحقيبة أخرى في الجهة الثانية فيها أوراق مهمة، أمي محنيّة الظهر، كانت تحمل حقيبة خفيفة وتمسك كريم من يده، زوجتي تحمل نادين بيد، وتدخل يدها بحقيبة جر حتى الكوع، وكفها يمسك كريم من ياقته، خالي جورج يحمل حقيبتين كبيرتين، تلك الحقائب كانت كل ما بقي لنا من حياة عمرها 40 عاماً، نسير بثقل شديد بسبب هواء المحركات القوي جداً والساخن جداً.. سقط أكثر من شخص في الطريق إلى الطائرة، ولم نحاول كمدنيين مساعدتهم، نعم أعترف أن غريزة البقاء كانت أقوى من كل شيء في تلك اللحظات، لكن جنود المطار لم يتركوهم، وركضوا وحملوا كبار السن إلى الطائرة.
مدخل الطائرة ليس درجاً يصعد إليها كما سيتوقع البعض، بل هو الباب الخلفي (الرمبة)، وكانت (الرمبة) ملساء جداً.
وصلنا.. صعد الكبار وساعدناهم، صعد الجميع، بقينا أنا وخالي وشاب ورجل كبير آخر الصاعدين، وكلما حاولت الصعود، سحبني ثقل الحقيبة الكبيرة إلى الأسفل، يساعده حذائي الرياضي الأملس من الأسفل أيضاً. محاولة، اثنتان، ثلاثة ولم أدخل إلى الطائرة.
فظهر فجأة أعلى الباب، ثلاثة جنود أو أربعة، مع كابتن الطيارة، ضابط برتبة مقدم، ضخم البنية خشن الملامح وقال: (أكتر من هدا العدد ما فينا نطالع، مشان سلامتكن وسلامتنا.. انتو للطيارة الجاية)، أيضاً لن أنسى ما حييت مشاعري في تلك اللحظة، طيارة جاية؟ وإن لم تصل الطيارة
رقم العدد:4438